في أحد أركان مقبرة القرية، الواقعة وسط بنايات جديدة، زحفت إليها وكأنها فعلتها خصيصاً لتحضن أرواح من سبقونا إلى العالم الآخر، تلطم المرأة الثكلى خديها، وتضع التراب فوق رأسها، تخبط بيديها على الباب الإسمنتي، الذي يبدو من لونه أن أحدهم قد دُفن حديثاً، تنادي بأعلى صوتها "ليه كده يا لبنى؟". تبكي بحرقة، تفقد السيطرة على دموعها، التي أصبحت كشلالٍ متدفق، من حولها تتناثر سيدات عائلتها حول المقبرة من كل جانب، إضافة لأخريات يتناوبن تقديم التعازي، "البقية في حياتك يا أم لبنى". إنها "زيارة الخميس"، حيث يؤمن البعض في القرى المصرية أن زيارة القبور لازمة في هذا اليوم، كأيام الأعياد تماما، جميع نسوة القرية يذهبن بأبنائهن وأحفادهن، ليتحدثن مع ذويهم المتوفين، يطمئنهن على "الحال والمحتال". "يا أبا محمد... دا مصطفى ابن محمد، أحضرته اليوم ليسلم عليك"، وتعود الجدة لتخاطب الصغير، "سلم على جدك يا مصطفى"، الطفل بكل براءة "إزيك ياجدو...". حوار سمعته بين إحدى النساء وحفيدها وزوجها المتوفى، على مقربة من مقبرة عمتي، التي جئت لزيارتها خصيصاً، شاهد القبر يقول "هنا ترقد فلانة، وهذه مقبرة عائلة فلان"، عائلات بأكملها ترقد هنا، "ياااه هذه نهايتنا إذن". الجميع هنا في القرية يعرفون بعضهم البعض، والجميع أيضاً يُولي اهتماماً خاصاً ببناء مقبرة العائلة، مهما بلغت تكلفتها المرتفعة إلى حد كبير مقارنة حتى بمنازل الأحياء. يوم الخميس تحديداً تعج مقابر القرية بالأحياء، جميعهم جاؤوا للزيارة، فهذا يسقي "صبار" مقبرة أبيه؛ إذ يؤمن حسب المعتقدات الشعبية أنه يمنع عن والده عذاب القبر، وهذه تتحدث مع زوجها المتوفى، وتلك تقف منتظرة أخواتها ليقرأن القرآن لوالدهن، وهؤلاء الصبية يجرون فرحين غير مكترثين بكل تلك المشاهد. ظل صوت أم لبنى يرن في أرجاء المقبرة، لا أعرفها، سألت العامل عن حالتها، قال "لبنى فتاة صغيرة 15 عاماً انتحرت فجأة، تناولت السُم، لا يعرف أحد لماذا فعلت ذلك، البعض يقول أنها حالة اكتئاب أصابتها"، عرفت بعد ذلك أنها عانت من فقر عائلتها، فوالدها عامل بسيط، ووالدتها لا تعمل، كانت لا تستطيع الحصول على أي من متطلباتها، مقارنة برفيقاتها، وبعقلية "صغيرة" انتحرت، إنه "الفقر الذي يهد الرجال، ما بالك تلك الطفلة"، أحدث نفسي، يرد عامل القبر "ربنا يسامحها بقى ماتت كافرة"، لا أرد، أفكر فيها طيلة اليوم لا أعرف كيف كانت حياتها، وأعود لمحادثة نفسي "السماء ستكون أحن عليها كثيراً من أهل الأرض". قالت دراسة لمؤسسة النهوض بأوضاع الطفولة، التي أعلن عنها في نهاية العام 2015، إن هناك نسبة كبيرة من الأطفال المصريين المنتحرين بسبب عدم قدرة أهلهم المادية أو الضغط النفسي في سن المراهقة، وتحتل الإناث نسبة 46% فيما يحتل الذكور نسبة 54%.
ماذا لو عجزنا عن دفن أحبائنا؟
القبر "يُبرد" قلوبنا، فهناك يمكننا التحدث معهم، حتى ولو من خلف جدار إسمنتي، وحتى إن لم نزُرهم بشكل مستمر، يكفي أن نحس فقط أنهم موجودون، ووجودهم يعزي قلوبنا عن آلام الفقد. خمس سنوات لم تجف دموعه، خمس سنوات من الحزن والانتظار... عم محمود عانى آلام الفقد مرتين، الأولى عندما "غاب" ابنه، والأخرى عندما لم يتمكن من دفنه، فهو لا يعرف مكان جثته، ولا يعرف قبراً يشكو إليه أوجاعه. عاش الرجل 5 أعوام كاملة من الحزن على ابنه، الذي سافر إلى اليونان عن طريقة أحد سماسرة الهجرة غير الشرعية، في رحلة ضمت عدداً كبيراً من أبناء محافظته، حلم الشاب الصغير أن يُزوج أخواته البنات، وأن يجمع المال اللازم لتنفيذ مشروع يكفل لأسرته عيشة كريمة، إلا أنه خرج ولم يعد. أصبح بين عشية وضحاها لا يعرف شيئاً عن ابنه، ولم يتسلم حتى جثته. قال بعض الشباب الذين رافقوه في رحلته، "آخر مرة رأيناه معنا على حدود اليونان كان الجليد كثيفاً، وكان يبدو منهكاً جراء الجري من شرطة الحدود اليونانية، ربما مات هناك لا نعلم". رغم تأكيدات عدة جاءت لعم محمود أن ابنه قد مات، لكنه تمنى أن يدفن جثته بنفسه حتى يتأكد من موته، فلماذا يُحرم من زيارة قبره؟ بعد مرور 5 سنوات على اختفاء ابنه، استخرجت الزوجة شهادة وفاة له، ويوم تسلمها، توفى عم محمود كمداً على ابنه الغائب. في نهاية العام 2016 أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن عدد ضحايا مركب رشيد المحملة بحوالي 366 شخصاً في رحلة هجرة غير شرعية بلغ حوالي 202 قتيل، تم التعرف على 92 جثة منهم فيما بقى 110 في عداد المجهولين.. مثلهم مثل ابن "عم محمود"، وجميعهم ضمن سلسلة متصلة لموتى فقدوا الأمل في أوطانهم، وهجّرتهم الحروب أو الفقر والتجويع في النهاية لتجمعهم "مقابر البحار"، أو الانتحار أو حتى الموت كمداً. أتذكر تلك المقولة، التي يرددها البعض، بأن "وضعنا كمصريين أفضل من سوريا والعراق"، أريد أن أخرس كل من يقول ذلك، "لا إحنا زيهم ونصف، جميعنا نعيش بلا أمل في وطن ضائع... بيد أنظمتنا الغبية". "حديث الحدائق"... مقابر تخيلية للشهداء السوريين "وضعوني تحت شجرة الرمان، التي زرعتها أمي من أجلي، لم تكن هناك أصوات أخرى غير صوت القصف والتربة، التي تغطي جسدي شيئاً فشيئاً". يأتي هذا الصوت من بعيد ليحكي قصة رجل عُرف باسم عبد الواحد، يخبر الزوار، وهم يقربون رؤوسهم من شاهد قبره، بأن مشاركته في الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد، أفضت إلى اعتقاله وتعذيبه، وعندما أُطلق سراحه، انضم إلى المقاومة. "حديث الحدائق" عمل فني تفاعلي استلهمته المخرجة اللبنانية تانيا الخوري من قصص الانتفاضة السورية، حيث تأثرت بصورة لأم تحفر قبراً لابنها في حديقة منزلها الخلفية، لأن الجنازات أصبحت شديدة الخطورة وأصبح بناء مقبرة في المنزل "أكثر أماناً"، وهو ما تفعله معظم الأسر السورية، حتى وصل الأمر للدفن في الحدائق العامة، لتصبح مليئة بالجثث المصفوفة، ربما هم لا يستطيعون تمييز قبر عن آخر. "بذلك يمكن للحدائق أن تتحدث عن حكايات من دُفنوا بها".. تقول تانيا. يقوم المشروع على حفر قبور في إحدى الحدائق خلال معرض تمثيلي يُطلب من كل عشرة زوار في المرة الواحدة، خلع أحذيتهم وجواربهم، وارتداء معاطف طويلة واقية من المطر، ويُمنح لكل شخص منهم بطاقة مكتوب عليها باللغة العربية، اسم لأحد القتلى في السنوات الأولى من الانتفاضة السورية، في أماكن مثل حلب وحماة. الأضواء قاتمة وهناك تربة وُضعت للتو على عشر شواهد قبور خشبية، يحمل كل منها اسم أحد ضحايا الحرب، يركع الزوار، حسب التعليمات، ويستخدمون أيديهم لإبعاد التراب عن شاهد القبر لسماع قصص الضحايا. تُقرأ القصص بواسطة ممثلين وتستند في الأساس إلى شهادات أهالي أصحاب القبور. بدأ المشروع في لبنان عام 2014 وتُرجم بعد ذلك للفرنسية والإنجليزية والإيطالية في محاولة لخلخلة ضمير العالم على أزمات السوريين، وتبقى القبور شاهداً آخر على إجرام النظام.أتذكر تلك المقولة، التي يرددها البعض، بأن "وضعنا كمصريين أفضل من سوريا والعراق"... لا إحنا زيهم ونصف
وضعوني تحت شجرة الرمان، التي زرعتها أمي من أجلي، لم تكن هناك أصوات أخرى غير صوت القصف والتربة، التي تغطي جسدي شيئاً فشيئاً
رائحة المقابر... رائحة لأوطان مسلوبة
إن كان السوريون لا يجدون مقابر لأحبائهم ويدفنونهم في الحدائق، حتى وإن هاجمها النظام، فهم على الأقل يدفنون موتاهم ويستطيعون قراءة الفاتحة على أرواحهم، ما بالك بهؤلاء الذين يعيشون في بلاد اللجوء، معظمهم دفنوا في مقابر البحار، والبعض الآخر لا يجد مقبرة. المواطن السوري أحمد المصطفى، أحد اللاجئين السوريين في إحدى بلدات منطقة البقاع شرق لبنان توفى أطفاله الثلاث في فترات متتالية، وكانت الطامة الكبرى هي عدم قدرته على دفنهم، وهو عامل بناء بسيط لا يستطيع استئجار مدفن تبلغ تكلفته 250 دولاراً، وهو مبلغ كبير بالنسبة لحالته. دفن أحمد أول طفلين بمقبرة أحد معارفه، أما آخر طفل متوفى فقد تكبد أحمد عناء السفر إلى قرية مجاورة حاملاً جثته بين يديه، ليدفنه في مقبرة أخرى لعائلة رأفت بحاله، وتبعد عن مكان إقامته بحوالي 3 ساعات. "دفنت ابني، حظي أفضل من كثيرين هنا لا يعرفون شيئاً عن قبور ذويهم، في النهاية أستطيع أن أشم رائحة وطني في قبر ابني حتى إن كان هذا القبر بعيداً نسبياً، أستطيع زيارته في وقت لا أستطيع فيه زيارة وطني"... يقول المصطفى.المقابر الافتراضية... هل تحل الأزمة؟
في روايتها طشاري، تحاول الكاتبة العراقية إنعام كجة جي، حل أزمات اللاجئين، الذين يفشلون في زيارة مقابر أحبائهم، فبطلة الرواية وردية إسكندر الطبيبة الثمانينية، التي أجبرتها ظروف الأحداث في العراق على الهجرة، كغيرها من عائلات مسيحية تعرضت للتهجير والتشريد أو فقد أحد أفرادها في حوادث تفجير الكنائس، فكانت ترى يوماً ما أن الانتقال من مدينة عراقية إلى أخرى هجرة، إلا أن الهجرة الحقيقية فُرضت عليها كغيرها من اللاجئين. في باريس، حيث هاجرت، تغزل بكلماتها معاناة اللاجئين وتتحدث عن معاناتها كأنها تتحدث عن هؤلاء جميعا: "ظروف البلاد تجبرها على الرحيل إلى باريس، بعد أن توزعت عائلتها في كل أقاصي الأرض، كأن جزاراً تناول ساطوره وحكم على أشلائها أن تتفرق في كل تلك الأماكن، رمى الكبد إلى الشمال الأمريكي، وطوّح بالرئتين صوب الكاريبي، وترك الشرايين طافية فوق مياه الخليج، أما القلب، فقد أخذ الجزار سكينه الرفيعة الحادة، وحزه رافعاً إياه، باحتراس، من متكئه بين دجلة والفرات ودحرجه تحت برج إيفل". وفي باريس صارت صداقة بينها وابن ابنة أخيها، الذي أخبرته برغبتها في العودة للعراق لتدفن في ترابه، يُنشئ الصبي مقبرة إلكترونية ويجمع شتات عائلتها المتفرقة، يصنع مقابر للأحياء بجوار من رحلوا، أشعرتها ببعض السعادة وحققت حلماً بجمع الشتات، لا أمل في تحقيقه على أرض الواقع، بالضبط كاسم الرواية "طشاري" أي المشتت المُتَفرق. هل يمكننا أن نعوض زيارة مقابر ذوينا بنظرة على مقبرة إلكترونية؟ وهل يمكن أن يعزينا ذلك في وقت أصبحت المساحة الافتراضية فقط هي التي تجمعنا. منصات إلكترونية ظهرت مؤخراً لتعبر عن نفس المضمون، فيمكنك اختيار مقبرتك وتزيينها بالورود أو جعلها منصة لجمع الصدقات أو أن تدعو الآخرين للتبرع بصدقة من أجلك وربما يستمر الأمر لبعد وفاتك، كل ذلك في فكرة نفذها مجموعة من الشباب المصريين تحت اسم "in memory of". تقول إسراء محمد، وهي إحدى المشاركات في دعم "مقبرة افتراضية" لصديقتها "مي". "الفكرة جديرة بالاهتمام، أتبرع يومياً لصديقتي التي لقت حتفها في حادث سير، وكأني أقرأ لها "الفاتحة" أمام قبرها الذي لا أستطيع زيارته، لذا أزورها افتراضياً، وسيصلها ثواب صدقتي". تتنوع المشروعات التي تدعمها "منصات الأموات" بالموقع ما بين إدخال الكهرباء والمياه للمنازل الفقيرة، أو دعم مستشفيات أطفال وغيرها، ويعتبرها البعض نوعاً من الدعم النفسي للأحياء، وقبلة على جبين الأموات.رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.



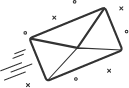
انضم/ي إلى المناقشة
مستخدم مجهول -
منذ يومتعليقا على ماذكره بالمنشور فإن لدولة الإمارات وأذكر منها دبي بالتحديد لديها منظومة أحترام كبار...
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامUn message privé pour l'écrivain svp débloquer moi sur Facebook
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامالبرتغال تغلق باب الهجرة قريبا جدااا
Jong Lona -
منذ 4 أيامأغلبهم ياخذون سوريا لان العراقيات عندهم عشيرة حتى لو ضربها أو عنقها تقدر تروح على أهلها واهلها...
ghdr brhm -
منذ 4 أيام❤️❤️
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ 6 أيامجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...