تحرصُ أمّي دائمًا على تذكيري بمدى خوفها عليّ؛ فتعبّر أحيانًا عن هذا الخوف بلطافة وتكتفي بقولها "ديري بالك على حالك"، وأحيانًا أخرى كثيرة، تعبّر عن هذا الخوف بتطرّفٍ مُدهش كما لو أنها تستنكر عمليّة إطلاقي إلى الحياة وتطالب بإعادتي إلى أحشائها فورًا وإلى الأبد. كثيرًا ما كنت أشعر بالغضب من بعض هذه التصرّفات، بل حتّى بالإهانة – فكيف تطلب أمّي من ابن عميّ الطفل الذي لم يتجاوز عمره العشر سنوات أن يرافقني إلى دكانٍ لا يبعد عن المنزل عشر خطوات؟ وكيف لها أن تزرع بيننا ميزان قوى كهذا؟ فأنا الأكبر! لكنني سريعًا ما كنت أنسى وأغفر، فهذه المواقف كانت تنتهي بالتبرير السائِد الشائِع: "هذا كلّه لأني بحبّك".
كبرتُ ووجدتُ نفسي أتصرّف بنفسِ طريقة أمي، كما وجدتُ غيري من النساء يتصرّفن بنفس الطريقة، أحيانًا نقول "يعني شو بدّه يصير؟" و"خلص هبل"، وأحيانًا، كما تقول صديقة: "بسمحش لحالي أنزل أشتري أكل بالليل حتى لو كنت ميتة جوع". كبرتُ وفهمتُ أن أمي لا تكمِل تبريرها الجميل، ربّما لإبقائه جميلًا، فالحبّ دومًا أجمل من أيّ شيء آخر. لكنّني اليوم أفهم أن "هذا كلّه لأني بحبك ولأنه العالم شرس وبخوّف".
وهكذا، يكون هذا درسنا الأوّل – شيء ما خارج البيت وأحيانًا في داخله يهدّدنا كنساء من دون الرجال ولو كانوا في العاشرة من عمرهم. تهديدٌ لا مفرّ منه، وبالتالي خوفٌ لا مفرّ منه. شراسةٌ ما تُوجّه نحونا. فنتربّى منذ الصغر ونتعلّم كيف ننجو بأنفسنا، وكأننا مُرغمات أن نُجيب عن السؤال: "كيف أعود الى البيت سالمة...أيوجد شيء أفعله؟". وفي النتيجة، يصبح "هذا كله" أرضًا خصبة للوم الضّحية حين تقع – أوليس من مسؤوليتها أن تنجو؟ هي مسؤوليتها منذ الطفولة. منذ أن كنّا في المدارس الابتدائية ولم ندخل إلى المراحيض وحدنا.
نتربّى منذ الصغر ونتعلّم كيف ننجو بأنفسنا، وكأننا مُرغمات أن نُجيب عن السؤال: "كيف أعود الى البيت سالمة...أيوجد شيء أفعله؟". وفي النتيجة، يصبح "هذا كله" أرضًا خصبة للوم الضّحية.
نكبر وندرك أننا مهما فعلنا، لا ننجو وحدنا أبدًا – لا الصمت ولا الحجاب ولا البيت ولا المناصب ولا حتى الطفولة باستطاعتها توفير الحماية لنا من أيّ شيء – فندرك أن لا بدّ من مسؤول آخر غيرنا. وهنا، تبدأ الحرب في توجيه إصبع الاتهام إلى من يستحق.
حين أدقق في تصرفات النساء اليوميّة وأسأل لمَ نتصرّف بهذه الطرق؟ وما الذي يجعل تصرّفاتنا متشابهة ومشتركة؟ أجد جوابًا واحدًا: إنه الخوف. خوفٌ خفيّ من أن نكون ضحيّةً قادمة، نغفل عنه ولا نلاحظه – بل نعتاده دون أن نشعر – ونباشر حياتنا خائفات دون أن نعي ذلك.نكبر وندرك أننا مهما فعلنا، لا ننجو وحدنا أبدًا – لا الصمت ولا الحجاب ولا البيت ولا المناصب ولا حتى الطفولة باستطاعتها توفير الحماية لنا من أيّ شيء – فندرك أن لا بدّ من مسؤول آخر غيرنا. وهنا، تبدأ الحرب في توجيه إصبع الاتهام إلى من يستحق، وتبدأ سيرورة التحرّر من هذه المسؤوليّة، ويُعلن عن رغبة النساء في الحياة وممارسة إنسانيتهن. وبالرغم من أننا نتغيّر ونحاول التغيير، لا نستطيع الهروب من السؤال نفسه – وأحيانًا دون أن نعي ذلك أو نشعر – كيف أعود إلى البيت سالمة؟ وهل من شيء أفعله؟ بيد أن الإجابات عن هذا السؤال وما توجبه باتت وكأنها عادات طبيعيّة، رغم معناها الوحيد، أنها وفي نهاية المَطاف، منبعها هو الخوف. نحن لا ننسى ضحايا النـساء؛ ليتنا قادرات على فعل ذلك. نحن نتعرّف جيّدًا على الضحايا، ونحفظُ تفاصيل الأحداث ونسترجِعُها في كلّ موقفٍ يُجبرنا على ذلك. وكأن الضحيةَ تُمسي شبحًا في حياتنا رغمَ حبّنا لها؛ فمع كلّ جريمة تحدُث ومع كلّ مكانٍ تحدث فيه جريمة، نَعي أن العنف قد وجد سبــيلًا آخر إلينا. والخوف لا يكون عابرًا. فحين تُقتل امرأة في سيّارتها، نخاف سيّاراتنا: "كل مرة بطلع أسوق بهتم أقفّل كل الأبواب حتى قبل ما بحط القشاط"...وحين يتمّ اختــطاف امرأة، نخاف سيـارات الأجرة: "ببعث رسالة إني ركبت، وببعث رسالة إني وصلت"، "ركبنا تاكسي وصاحباتي وصّلوني عبيتي مع إنه أبعد وأغلى بس عشان ما أكنش لحالي"... ونَخاف الشوارع: "بضل ماسكة التلفون وبتصل عَ حدا أطق حنك عن أي اشي عبين ما أوصل، وإذا ما حدا رد عليّ بعمل حالي عم بحكي". وحين تموت فتاة في حادث سير مع شاب نُمنع – أو حتّى نَمنَع أنفسنا – من مرافقة الرجال ولو كانوا أصدقاء: "من لمّا توفّت هديك الصبية بحادث السير مع صديقها، وطلع عليها حكي، بطّلت أقدر أركب مع حدا خصوصي بالليل... هني أهلي ضد الحكي بس خلص عرايهن هيك أفضل". وأحيانًا، لسنا بحاجةٍ لمعرفة جريمةٍ ما حتى تتأثر حياتنا اليومية، فهو خوفٌ عام من كل شيء وفي كلّ مكان: "لما استأجرت بيت اهتميت يكون سياج ع الشبابيك، ويكون عالي بس بدون سطح... عشان ما حدا يفوت"، "لما بلبس جينس بهتمّ الاقي بلوزة طويلة تغطّي...مريح أكثر"، "مش ممكن أفوت أعبّي بنزين بالليل"، "صرت اتفادى المحلات المزدحمة، من بعد ما شب مرة ضل ماشي وراي ورفعلي الجاكيت"، "هو شكله شغل منيح بس كيف هيك قِبِل يوظفني بدون مقابلة؟!" جميعُها اقتباسات عن نساء شابّات من بيوت مختلفة، يمكن وصفها بالآمنة والداعمة على أقلّ تقدير، ومع هذا نشهَد فعلًا أن لا مفرّ من هذا التهديد ومن هذا الخوف. فحين أدقق في تصرفات النساء اليوميّة وأسأل لمَ نتصرّف بهذه الطرق؟ وما الذي يجعل تصرّفاتنا متشابهة ومشتركة؟ أجد جوابًا واحدًا: إنه الخوف. خوفنا على أنفسنا أو خوف غيرنا علينا. خوفٌ خفيّ من أن نكون ضحيّةً قادمة، نغفل عنه ولا نلاحظه – بل نعتاده دون أن نشعر – ونباشر حياتنا خائفات دون أن نعي ذلك. بيد أن العنف موجّهٌ ضدّنا بجميع أشكالِه، ومع كلّ جريمة نزداد ثقلًا ونُطالَب بأن نقف أمام مفارق طرق أكبر وأكبر، بدءًا من نقاشاتنا مع أهلنا ومع أصدقائنا ومع من نحبّ، وحتّى نقاشاتنا مع أنفسنا. هكذا يصير ثمن حريّتنا أغلى، وهكذا نضطرّ أن نزداد قوّة. أضف أن هذا النضال بخلاف الكثير غيره، يتميّز – أو يشذّ – بأننا مُرغمات على خوضِه بشكلٍ شخصيّ في قراراتنا وعاداتنا اليوميّة، دون أيّ فرصةٍ للاستقالة: "صراحة أنا بَحاول ما أهتمش وأضل أتصرّف كيف بدّي... إذا صار اشي بتصرّف بنفس اللحظة... بس أمي قالت لي إني لمّا بردّش عالتلفون معناها انخطفت!"
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.



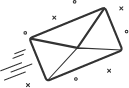
انضم/ي إلى المناقشة
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ 20 ساعةجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...
Tayma Shrit -
منذ يومينمدينتي التي فارقتها منذ أكثر من 10 سنين، مختلفة وغريبة جداً عمّا كانت سابقاً، للأسف.
مستخدم مجهول -
منذ يومينفوزي رياض الشاذلي: هل هناك موقع إلكتروني أو صحيفة أو مجلة في الدول العربية لا تتطرق فيها يوميا...
مستخدم مجهول -
منذ يوميناهم نتيجة للرد الايراني الذي أعلنه قبل ساعات قبل حدوثه ، والذي كان لاينوي فيه احداث أضرار...
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 4 أيامأرسل لك بعضا من الألفة من مدينة ألمانية صغيرة... تابعي الكتابة ونشر الألفة
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 4 أياماللاذقية وأسرارها وقصصها .... هل من مزيد؟ بالانتظار