استمدّت المخرجة لينا سنجاب العنوان، من عبارةٍ كتبتها شخصيّات الفيلم على الحائط، قبل رحيلها عن مدينة حلب: "مجانين حلب مرّوا من هنا".
أغلب شخصيات الفيلم من الكادر الطبّي العامل في مستشفى القدس، وهو آخر مستشفى بقي يعمل تحت الأرض، في المناطق التي وقعت تحت الحصار في مدينة حلب، في العام 2016، بعددٍ محدودٍ من الأفراد، وفي ظلِّ نقصٍ حادٍّ في المواد الطبيّة الضروريّة، استمرّ الكادر الطبّي في تقديم الخدمات، لآلاف المدنيين المتواجدين في الأحياء المحاصرة من مدينة حلب في تلك الفترة. بالإضافة إلى الحصار، كانت هذه المناطق ترزح تحت القصف المستمرِّ والمتواصل من قبل الطيران الحربي، وهو سلاح لا يملكه على الأراضي السوريّة، إلا الجيش التابع للنظام الحاكم.
"الجنون" في عنوان الفيلم، كناية عن طريقة عيش هذا الطاقم الطبّي الذي قرّر أفراده عدم الرحيل عن مدينة حلب، رغم الوضع الخطر والمأساوي الذي تعيشه المدينة، كناية عن أسلوب حياتهم المخصّصة بالكامل للإنهماك بالعمل إلى حدِّ استقبال أعدادٍ هائلةٍ من المصابين والجرحى، كناية عن حالة العطاء المستمرّة والتي تفوق التحمّل، وكناية عن التعلّق الشديد بالمدينة، ومحاولة مساعدة المحاصرين فيها حتى آخر طاقتهم وقدراتهم.
"مجانين حلب مرّوا من هنا" هو حكاية مستشفى طبّي، حيث الموتى، الجرحى، المصابون، والأطفال الرضّع، في مدينةٍ عانت من حصارٍ شديدٍ، واعتُبرت المعارك العسكريّة فيها من أعنف المعارك التي دارت على الأرض السوريّة في السنوات الماضية
الفيلم من إخراج لينا سنجاب وتصوير عبد القادر حبق وميار الرومي، وقد قُدّم في عرضٍ خاصٍّ ضمن إطار فعاليات مهرجان Almost There السينمائي، من تنظيم مؤسّسة هاينرش بول في سينما ميتروبوليس صوفيل، قدّمت مديرة مؤسّسة هاينريش بول في بيروت الفيلم بالقول: "حكايات الفيلم نموذجٌ في كيفيّة تعاضد المدنيّين في حال الحروب، وما الذي يمكن أن يقدّموه لبعضهم البعض في فترات الأزمات".
هي حكاية مستشفى طبّي، حيث الموتى، الجرحى، المصابون، والأطفال الرضّع، في مدينةٍ عانت من حصارٍ شديدٍ، واعتُبرت المعارك العسكريّة فيها من أعنف المعارك التي دارت على الأرض السوريّة في السنوات الماضية، ما دفع القائمون على الفيلم للتحذير في بدايته من مقدار القسوة التي تحملها بعض مشاهد الفيلم. وتصرّح المخرجة في هذا الصدد: "كانت تجربةً صعبةً في صناعة فيلمٍ وثائقي من مادّةٍ مصوّرةٍ بظروفٍ صعبة وليست ذات طابعٍ وثائقي"
يبدأ الفيلم بسلسلة من اللقطات البانوراميّة للمناطق المدمّرة من مدينة حلب، ومن ثمّ مجموعة من اللقطات تعرض ألعاب الأطفال في العيد، مثل المراجيح، القلّابات، والركوب على الأحصنة، تركّز اللقطات الافتتاحيّة في الفيلم على الطفولة في المدينة، فنشاهد مجموعةً من الأطفال الذين يتجمّعون وينشدون الأغاني، لكن من خلف تجمّعهم نلمح امتداداً لمقبرةٍ تضمُّ أعداداً كبيرةً من القبور، كأن هذه اللحظات الافتتاحيّة ترمز إلى أن الفيلم يتراوح بين الطفولة والموت.

الطبيب حمزة الخطيب، مدير المشفى وأحد الشخصيات الرئيسية في الفيلم، بقي في حلب منذ العام 2011، مدفوعاً بإيمانه بضرورة العمل الطبّي في مدينة تعيش هذه التجربة العنفيّة. يعرّفنا في شهادته في الفيلم عن حال المستشفى الوحيد الموجود في المناطق المحاصرة، ويتحدّث عن شروط العمل في ظلِّ غياب الماء، الكهرباء، الوقود، والأوكسجين، وفي ظلِّ انعدام إمكانيّة الصيانة الدوريّة اللازمة لاستمراريّة عمل المستشفى، يقول: "أنا طبيب وأنا مدير المستشفى في الوقت عينه، لقد قسّمت أيامي بحيث تكون النهارات للجانب الإداري، وفي المساء تبدأ مرحلة الإسعافات"، يروي الطبيب حمزة الخطيب كلَّ ذلك، بينما نتابعه عبر الفيلم، وهو يقوم بعمليات الإسعاف ومساعدة الجرحى والمصابين، بلا توقّف على طول دقائق الفيلم.
حين تخرج الكاميرا خارج المستشفى تُطلعنا على مقدار الدمار الذي حلَّ بالمدينة، نرى الأطفال ينتشلون ألعابهم وأغراضهم من تحت الدمار والأنقاض، نتابع حكاية طفلٍ يحاول أن يجمع الخشب من الأنقاض ليوصلها لعائلته، كي تستخدمها للطهي والتدفئة.
شخصيّةٌ أخرى استثنائيّة من الطاقم الطبي للمستشفى وهي أم ابراهيم، ممرّضة ومُسعفة، تركت زوجها وأطفالها في تركيا وعادت للعمل في المستشفى في حلب، تتساءل أم ابراهيم: "هل من الصواب أن أترك عائلتي وأطفالي في تركيا، وأعود لمساعدة الناس في حلب؟" لقد أجابت أم إبراهيم على هذا الصراع – السؤال بالاندماج في العمل لأجل الجرحى والمصابين في المدينة دون توقّفٍ وبلا هوادة.
شخصيّات نسائيّة مثل "أم ابراهيم، أم أمير، وأم يزن" منخرطة في العمل الطبي، سمحت أن يقدّم الفيلم لمحةً عن المشاركة النسويّة في الحدث السوري. مشاركة المرأة موضوعة غابت عن الإعلام والسينما التي تناولت القضية السوريّة. الأطفال أيضاً حاضرون في لقطات الفيلم، أطفال في أروقة المستشفى، يصلون غرف الإسعاف بعد تعرّضهم للقصف، أحياناً يساعد الأطفال بعضهم البعض: طفل حمل أخويه الاثنين لإنقاذهم من القصف، طفل يغسل وجوه أخوته المطلخة بالدماء والدمار، وهناك طفل يرافق والده لينقذ الابن، الأب.
يتعرّض المستشفى للقصف من قبل الطيران، فيهرع الكادر الطبي للاطمئنان على حواضن الولادات، وعلى وضح الجرحى في غرفة الحالات الخطرة، يقولون لبعضهم البعض دون أن يتوقّفوا عن العمل: "استودعناكم"، بمعنى الاستعداد للقاء الموت ومفارقة الحياة أثناء العمل.
أحد شخصيّات الفيلم هو الجرّاح في المشفى، نتابع تفاصيل عملياته الدقيقة والتي يجريها على ضوء البطاريّة، لقد دُمّر منزله الذي كان في بستان القصر، نقل عائلته إلى منطقةٍ آمنةٍ، ومن ثم عاود مهمّته الأساسيّة في المستشفى. يروي في شهادته عن صعوبة العمل الطبّي في ظل قصف صواريخ الغراد، البراميل المتفجّرة، يروي كيف اعتاد رائحة الدم والموت وهو يقوم بعملياتٍ إسعافيّةٍ خطيرة. حين يسأله المصوّر أمام الكاميرا: "لماذا تبقى في حلب؟" يخبره الجراح عن أهمية قيام الطبيب بمهمّته الإنقاذيّة مهما كلّف الأمر.
في كلِّ مرة تخرج كاميرا الفيلم من المستشفى نتعرّف على حجم الدمار الذي يزداد في المدينة، الألعاب التي شغلها الأطفال في بداية الفيلم، نراها الآن خاليةً، المراجيح محطّمة، تأخذنا الكاميرا في جولة في أحياء حلب القديمة، الأسواق، الجامع الأموي الكبير، كلّها في حالةٍ من الدمار والخراب الهائل.

"لا وقت للدّفن"
"لا وقت لدفن الجثث" يقول الطبيب الخطيب، فحكاية الفيلم هي الصعوبات المهنيّة في ظلِّ الوضع الصعب الذي تعيشه المناطق التي تنشط فيها المستشفى. نقصٌ في عدد الكوادر الطبيّة، لقد صوّر المسؤول عن جهاز الأشعة في المستشفى ما يقارب ال 350 صورة خلال ثلاث ساعات في أحد الأيام، هو معرّض للإصابة بالسرطان لكثرة التقاط الصور الشعاعيّة. يروي الطبيب الخطيب هذه الحكاية، كمثالٍ عن شدّة ضغط العمل في ظلِّ ظروفٍ غاية في الصعوبة.
رغم كلِّ هذه الجهود تحاول شخصيات الفيلم أن تشرح التزامها المهني بكلماتٍ بسيطة، لا محاولات لالتماس البطولة، هم منقادون إلى رغبة المساعدة الطبيّة الوحيدة المتوافرة في المدينة، وهذه الاندفاعة هي الحرفيّة الحقيقيّة.
في إحدى مشاهد الفيلم، نرى الكادر الطبّي مع بعض سكّان الأحياء المحاصرة، وقد صوّروا فيديو لينشر على يوتيوب، يناشدون فيه الضمير العالمي والمجتمع الدولي أن يلتفت للأوضاع الصعبة التي تعيشها مناطقهم المنكوبة، حيث 300 ألف مدني يعيشون تحت القصف والحصار، رسالتهم أنهم في منطقةٍ تدمّرت فيها المستشفيات والمدارس، وهم ليسوا بإرهابيين، كما يحاول الإعلام أن يصوّرهم. لقد خرجوا بمظاهراتٍ سلميّة، ونراهم يستعيدون أغاني تلك الفترة، فيغنّون: "أنا طالع أتظاهر، ودمي بأيدي".
في الفيلم تتكرّر لقطاتٌ شعريّةٌ للشبابيك، شبابيك على المدينة، شبابيك المستشفى، نافذة على الثلج في مدينة لندن، ومنها الشبابيك على ذكريات الشخصيات، حيال ذلك، تبيّن المخرجة أنها اختارت تيمة الشبابيك لتحمل سرديّة الفيلم: "كاميرا الفيلم كانت تتحرّك بين داخل المستشفى وخارجه، وأحداث الفيلم تجري داخل حلب وخارجها، ومن هنا أتت فكرة النافذة كموضوعةٍ رمزيّةٍ - سرديّة في الفيلم"
يروي مصور الفيلم عبد القادر حبق، صعوبة حمل الكاميرا والتوثيق أمام حجم الألم ومشاهد معاناة الناس التي تحصل أمامه، يطرح سؤالاً جوهرياً عن مهنية المصوّر – الموثّق: "تتساءل أحياناً كمصوّر هل تساعد أم توثّق ما يحدث؟" وهو يختار المساعدة، كما يقول بشهادته داخل الفيلم.
من أين يستمدّ هذا الطاقم الطبّي شجاعة المغامرة؟ تقول إحدى شخصيّات الفيلم: "فكرة الموت الجماعي تمنح شعوراً بالاطمئنان"، نراهم يلقون النكات بشكلٍ مستمرٍّ ليتمكّنوا من الاستمرار في ضغط عملهم.
"بلا وطن، يعني بلا روح"

يتابع الفيلم شخصيّاته في المهجر، في أوروبا، واحد من الذين يتابعهم هو عبد القادر حبق، مصوّر الفيلم، يقدّم شهادته من لندن حيث انتقل للعيش هناك، يروي عن العلاقة مع الذكريات، مازال ماضي حلب يعاوده بين الحين والآخر، مايزال يشعر أنه يتراوح بين الماضي وبين تقبّل الحياة الجديدة.
يوثّق الفيلم لعملية المفاوضات التي جرت بين القوى المتصارعة في مدينة حلب، مشاهد متعدّدة عن عملية إخلاء الجرحى بين الطرفين في واحدةٍ من أعنف المعارك التي شهدتها سورية مؤخّراً. تتوقّف عمليات إجلاء الجرحى ليومين، ترافق الكاميرا شخصيات الفيلم والكادر الطبّي في أيام الانتظار للخروج من حصار المدينة، وفي ليالي الانتظار تلك، يكتبون على جدران أحد الأماكن التي جلسوا بها: "مجانين حلب مرّوا من هنا".
يتطرّق الفيلم لأهمية توثيق الحدث، وتتحدّث المخرجة عن صراع سرديّات بين القوى المتصارعة في سورية، والفيلم هو مساهمةٌ في الإضاءة على سرديّة مجموعةٍ من الشخصيّات العاملة في الكادر الطبّي في ظلِّ صراعٍ مسلّحٍ قاسٍ. أما ما ترويه المخرجة عن خياراتها في إظهار مشاهد القسوة، فهي تتحدّث عن الصراع الذي يعايشه صانع الفيلم، بين رغبة سرد المأساة كاملةً، وتهمة عرض المشاهد القاسية مباشرةً، تقول لينا سنجاب: "بين إظهار الحقيقة وعرض المشاهد القاسية، كانت قرارات صعبة، يجب أن ترى الناس حقيقة ما يجري"، ويؤكد المصوّر حبق، أن الناس في المناطق المحاصرة كانت تهرع إلى الكاميرا، في غاية تصوير مأساتها، ونقل الوضع المزري التي تعيشه عبر الكاميرا والسينما.
"بلا وطن، يعني بلا روح" تقول أم إبراهيم، التي تعبّر على الدوام عن تعلّقها وعن حبهّا لمدينة حلب. في مشاهد الإجلاء الأخيرة عن المدينة، مشاهد الرحيل عنها، تبكي أغلب الشخصيات للفراق القسري لحلب. وفي المشهد الأخير تبكي موسيقى الفيلم على آلة العود "موسيقى تصويريّة: الحارس المهيدي"، عند لقطة النهاية التي تصوّر الباصات الخضراء تحمل الأهالي والسكّان يغادرون منازلهم، يبتعدون عن ذكرياتهم، وعن الأماكن التي أحبّوها طوال حياتهم.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.






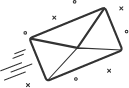
انضم/ي إلى المناقشة
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ يومجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...
Tayma Shrit -
منذ 3 أياممدينتي التي فارقتها منذ أكثر من 10 سنين، مختلفة وغريبة جداً عمّا كانت سابقاً، للأسف.
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامفوزي رياض الشاذلي: هل هناك موقع إلكتروني أو صحيفة أو مجلة في الدول العربية لا تتطرق فيها يوميا...
مستخدم مجهول -
منذ 3 أياماهم نتيجة للرد الايراني الذي أعلنه قبل ساعات قبل حدوثه ، والذي كان لاينوي فيه احداث أضرار...
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 5 أيامأرسل لك بعضا من الألفة من مدينة ألمانية صغيرة... تابعي الكتابة ونشر الألفة
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 5 أياماللاذقية وأسرارها وقصصها .... هل من مزيد؟ بالانتظار